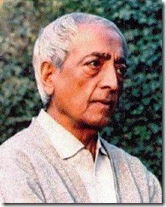الصُّـورة*
ج. كريشنامورتي
كنَّا بصدد استقصاء طبيعة الحب[1]، وقد توصَّلنا إلى نقطة تستلزم، على ما أعتقد، المزيد المزيد من نفاذ النظر، المزيد المزيد من وعي المسألة. ولقد اكتشفنا أن الحب، بنظر أغلب الناس، يعني الراحة، الأمان، ضمانةً طوال بقية العمر للإشباع العاطفي المستمر. ثم يأتي واحد مثلي ويسأل: “هل ذاك حبٌّ حقًّا؟”، ويسألك أن تنظر إلى دخيلة نفسك. فتحاول ألا تنظر لأن الأمر مزعج جدًّا – تراك تفضل مناقشة الروح أو الوضع السياسي أو الاقتصادي الراهن –؛ لكنك، حين تُحشَر في زاوية لتنظر، تدرك أن ما خُيِّل إليك دومًا أنه حبٌّ ليس حبًّا على الإطلاق، بل هو ترضية متبادلة، استغلال متبادل.
حين أقول: “ليس للحبِّ غدٌ ولا أمس” أو: “عندما لا يوجد مركز، عندئذٍ يوجد الحب”، فلهذا القول واقعية بنظري، لكنْ ليس بنظرك. قد تستشهد به وتحوِّله إلى وصفة، لكن ذلك لا يصح؛ إذ عليك أن تتحقق من الأمر بنفسك. لكنك حتى تفعل لا بدَّ من وجود حرية للنظر، تحرُّر من كل إدانة، من كل حُكْم، من كل موافقة أو مخالفة.
والآن، النظر – أو السمع – واحد من أصعب الأمور في الحياة؛ النظر والسمع هما الأمر نفسه. إذا كانت عيناك معميَّتين بمخاوفك تراك لا تستطيع أن ترى جمال مغيب الشمس. أغلبنا فقدوا صلتهم بالطبيعة، والحضارة تتَّجه أكثر فأكثر صوب المدن الكبرى. لقد صرنا أناسًا مدنيين أكثر فأكثر، نعيش في شقق مزدحمة وليس عندنا حتى غير حيِّز ضيق جدًّا للنظر إلى السماء المسائية والصباحية، ولهذا ترانا نفقد الصلة بقدر كبير من الجمال. لا أدري إنْ كنتم لاحظتم كم تضاءل عدد الذين ينظرون منَّا إلى شروق الشمس أو غروبها، أو إلى ضوء القمر، أو إلى انعكاس الضوء على صفحة الماء.
أما وقد فقدنا الصلة مع الطبيعة ترانا بطبيعة الحال ننزع إلى تنمية قدراتنا العقلية. ترانا نقرأ عددًا كبيرًا من الكتب، نذهب إلى الكثير جدًّا من المتاحف والحفلات الموسيقية، نشاهد التلفزيون، ونتسلَّى بطرق أخرى شتى؛ ترانا نقتبس إلى ما لا نهاية من أفكار غيرنا من الناس ونغالي في التفكير في الفن وفي الحديث عنه. فما الذي يجعلنا نتكل على الفن كلَّ هذا الاتكال؟ أهو شكل من أشكال الهروب أو الإثارة؟ إذا كنت على صلة مباشرة بالطبيعة، إذا راقبت حركة طائر يحلِّق، ورأيت جمال كل حركة في السماء، وشاهدت الظلال على التلال أو جمال وجه إنسان آخر، أتظنك سترغب بعدُ في الذهاب إلى أيِّ متحف لتشاهد لوحة ما؟ ربما لأنك لا تعرف كيف تنظر إلى الأشياء كلِّها حواليك تراك تلوذ بنوع من أنواع المخدر لتنبيهك إلى الرؤية رؤية أفضل.
هناك قصة عن معلِّم ديني تروي أنه كان من عادته أن يعظ تلاميذه كل صباح. وذات صباح، اعتلى المنصة وكان على وشك أن يبدأ عندما جاء عصفور صغير وحطَّ على حافة النافذة وبدأ يغرد، وراح يغرد بكل قوته. ثم توقف وطار مبتعدًا، فقال المعلِّم: “موعظة هذا الصباح انتهت!”
يبدو لي أن واحدة من أشد صعوباتنا هي أن نرى بأنفسنا رؤية واضحة حقًّا، لا الأشياء الخارجية فقط، بل الحياة الداخلية. حين نقول إننا نرى شجرة أو زهرة أو شخصًا هل ترانا نراهم فعليًّا؟ أم ترانا لا نرى إلا مجرد الصورة التي أوجدتْها الكلمة؟ أي أنك، حين تنظر إلى شجرة أو إلى غيمة ذات مساء مليء بالبهجة والضياء، هل تراها فعليًّا، لا بعينيك رؤيةً عقلية، بل رؤية كلِّية، تامة؟
هل اتفق لك يومًا أن تختبر النظر إلى شيء موضوعي كالشجرة من دون أيٍّ من التداعيات، أيٍّ من المعلومات التي اكتسبتها عنها، من دون أيِّ هوى، أيِّ حُكْم، أيِّ كلمات تشكِّل شاشة بينك وبين الشجرة وتحُول بينك وبين رؤيتها كما هي فعليًّا؟ جرِّبْ ذلك وانظرْ ما الذي يحصل فعليًّا عندما ترصد الشجرة بكيانك كلِّه، بكلِّية طاقتك. في ذاك الاستغراق، ستجد أنه لا يوجد راصد بتاتًا، بل يوجد انتباه وحسب. لا يوجد الراصد والمرصود إلا عندما ينعدم الانتباه. أما حين تنظر إلى شيء في انتباه تام فلا يوجد حيِّز لأيِّ تصور، لأيِّ صيغة، لأيِّ ذاكرة. إن فهم هذا من الأهمية بمكان لأننا نتباحث في شيء يستلزم تقصِّيًا شديد الدقة.
وحده ذهنٌ ينظر إلى شجرة أو إلى النجوم أو إلى مياه نهر متلألئة في ذهول تام عن النفس ذهنٌ يعرف ماهية الجمال؛ وحين نرى فعليًّا نكون في حال محبة. نحن نعرف الجمال عمومًا من خلال المقارنة أو عبر ما قام الإنسان بتجميعه، ما يعني أننا نعزو الجمال إلى غرض ما. أرى ما أعتبره مبنى جميلاً، وتراني أقدِّر ذلك الجمال بسبب معرفتي بالمعمار وبمقارنته بمبانٍ أخرى سبق لي أن رأيتها. لكني الآن أسأل نفسي: “هل هناك جمال من غير غرض؟” حين يوجد راصد هو الرقيب، المختبِر، المفكِّر، لا جمال هناك، لأن الجمال شيء خارجي، شيء ينظر إليه الراصد ويحكم عليه. ولكن حين ينعدم الراصد – وهذا يستلزم قدرًا كبيرًا من التأمل، من التقصِّي – إذ ذاك يوجد الجمال من غير الغرض.
يكمن الجمال في التخلِّي التام عن الراصد والمرصود؛ ولا يمكن للذهول عن النفس أن يكون إلا حين يوجد تقشف تام – لا تقشف رجل الدين، بخشونته وروادعه وقواعده وطاعته، لا التقشف في الملبس والفكر والطعام والسلوك – إنما تقشف البساطة الكلِّية الذي هو التواضع التام. إذ ذاك لا إنجاز هناك، لا سلَّم يجب تسلُّقه؛ هناك الخطوة الأولى فقط، والخطوة الأولى هي الخطوة الأبدية.
هَبْ أنك تسير بمفردك أو مع أحدهم وتوقفت عن الكلام. أنت محاط بالطبيعة، ولا كلب ينبح، ولا ضجيج سيارة عابرة، ولا رفرفة طائر حتى. أنت صامت تمامًا، والطبيعة حواليك صامتة كلها هي الأخرى. في تلك الحال من الصمت المستتب في الراصد والمرصود كليهما – حين لا يترجم الراصد ما يرصده إلى فكر – يتصف ذاك الصمت بخاصية جمال مختلفة. ليس هناك الطبيعة ولا الراصد. هناك حالُ ذهنٍ وحده كليًّا، تمامًا؛ إنه وحده، لا في عزلة، بل في سكون، وذاك السكون جمال. حين تحب، هل يوجد راصد؟ يوجد راصد فقط حين يكون الحب رغبة ولذة. أما حين لا تقترن الرغبة واللذة بالحب، إذ ذاك يكون الحب شديدًا. إنه، كالجمال، شيء جديد كليًّا كل يوم. وكما قلت، ليس له اليوم ولا الغد.
فقط حين نرى من دون أيِّ تصوُّر مسبق، من دون أيِّ صورة، نستطيع أن نكون على صلة مباشرة مع أيِّ شيء في الحياة. جميع علاقاتنا في الواقع علاقات “صورية” – بمعنى أنها قائمة على صورة من تشكيل الفكر. إذا كانت عندي صورة عنك وكانت عندك صورة عني، فنحن بطبيعة الحال لا يرى كلٌّ منا الآخر بتاتًا كما نحن فعليًّا. فما نراه هي الصور التي شكَّلها كلٌّ منا عن الآخر والتي تمنعنا من التواصل؛ ولهذا فإن علاقاتنا تنتهي إلى الإخفاق.
عندما أقول إنني أعرفك إنما أعني أني كنت أعرفك بالأمس. فأنا لا أعرفك فعليًّا الآن. كل ما أعرفه هو صورتي عنك. وتلك الصورة تجميع لما سبق لك أن قلتَ في مدحي أو في ذمِّي، لما سبق أن فعلتَه بي؛ إنها تجميع لمجموع الذكريات التي في حوزتي عنك. وصورتك عني تجميع بالطريقة ذاتها؛ وهاتان الصورتان هما اللتان تعقدان العلاقة وتحُولان بيننا وبين التواصل الحقيقي معًا.
لدى كلٍّ من شخصين تعايشا مدة طويلة صورةٌ عن الآخر تحُول بينهما وبين أن يكونا على علاقة حقيقية. إذا فهمنا العلاقة بوسعنا أن نتعاون، لكن التعاون لا يمكن له أن يوجد أصلاً عبر صور، عبر رموز، عبر تصورات إيديولوجية. بينما فقط حين نفهم العلاقة السوية بين بعضنا بعضًا توجد إمكانية الحب، والحب يمتنع عندما تكون عندنا صور. لذا من المهم أن تفهم – لا عقليًّا، بل فعليًّا في حياتك اليومية – كيف بنيت صورًا عن زوجتك، عن زوجك، عن جارك، عن ولدك، عن وطنك، عن قادتك، عن سياسييك، عن آلهتك – ليس عندك شيء غير صور!
هذه الصور توجِد الحيِّز بينك وبين ما ترصد، وفي ذلك الحيِّز يوجد نزاع. وإذن، فما سنعمل على اكتشافه الآن سوية هو إنْ كان من الممكن لنا أن نتحرر من الحيِّز الذي نوجِده، ليس خارج أنفسنا وحسب، بل في أنفسنا، الحيِّز الذي يجزِّئ البشر في جميع علاقاتهم.
والآن، فإن الانتباه بالذات الذي توليه لمشكلة ما هو الطاقة التي تحلُّ تلك المشكلة. فحين تولي انتباهك كاملاً – وأعني: بكل شيء فيك – لا يوجد راصد بتاتًا. هناك فقط حال الانتباه التي هي طاقة كلِّية، وتلك الطاقة الكلِّية هي أعلى أشكال الفطنة. وبطبيعة الحال، تلك الحال الذهنية يجب أن تكون صامتة صمتًا تامًّا؛ وذاك الصمت، ذاك السكون، يأتي حين يستتبُّ انتباه كلِّي، لا سكون منضبط. ذاك الصمت الكلِّي الذي ليس فيه راصد ولا الشيء المرصود هو أسمى أشكال الذهن الديِّن. لكن ما يحصل في تلك الحال لا يعبَّر عنه بكلمات لأن ما يقال بكلمات ليس الواقعة. فحتى تكتشفه بنفسك عليك أن تكابده.
كل مشكلة فهي مرتبطة بكل مشكلة أخرى، بحيث إنك إذا استطعت أن تحلَّ مشكلة واحدة حلاًّ تامًّا – ولا يهم أيُّها من المشكلات – لرأيت أن بوسعك أن تواجه سائر المشكلات الأخرى جميعًا في سهولة وتحلَّها. نحن نتكلم، بالطبع، على المشكلات النفسانية. لقد سبق لنا أن رأينا أن المشكلة توجد في الزمن فحسب، أي عندما نواجه القضية مواجهة ناقصة[2]. وإذن فيجب علينا، لا أن نعي طبيعة المشكلة وبنيتها فقط، فنراها رؤيةً تامة، بل وأن نواجهها عند ظهورها ونحلَّها على الفور بحيث لا تتجذَّر في الذهن. إذا أجاز المرء لمشكلة أن تدوم شهرًا أو يومًا، أو حتى بضع دقائق فحسب، فإنها تشوِّه الذهن. وإذن، فهل من الممكن للمرء أن يواجه المشكلة على الفور، من غير أي تحريف، ويتحرر منها على الفور تحررًا تامًّا، فلا يجيز لذكرى، لخدش طفيف في الذهن، أن يبقى؟ هذه الذكريات هي الصور التي نحملها معنا، وهذه الصور هي التي تواجه هذا الشيء الخارق المسمَّى بالحياة، وبالتالي يوجد تناقض، ومنه ينشأ النزاع. الحياة حقيقية للغاية – فالحياة ليست تجريدًا – وحين تواجهها بالصور تنشأ مشكلات.
فهل من الممكن للمرء أن يواجه كل قضية من دون هذا الفاصل الزمكاني، من دون الفجوة بينه وبين الشيء الذي يخشاه؟ إنه ممكن فقط حين لا تكون للراصد استمرارية – الراصد بوصفه باني الصورة، الراصد الذي هو كوكبة من الذكريات والأفكار، الذي هو حزمة من التجريدات.
حين تنظر إلى النجوم، هناك أنت الناظر إلى النجوم في السماء؛ السماء مترعة بنجوم ساطعة، هناك هواء منعش، وهناك أنت، الراصد، المختبِر، المفكِّر، بقلبك الموجوع، أنت، المركز، موجِد الحيِّز. تراك لن تفهم أبدًا حقيقة الحيِّز بينك وبين النجوم، بينك وبين زوجتك أو زوجك أو صديقك، لأنك لم تنظر قط من دون الصورة، ولهذا تراك لا تعرف ماهية الجمال أو ماهية الحب. تراك تتكلم فيه، تكتب عنه، لكنك لم تعرفه قط، ماعدا ربما عند فواصل نادرة من الذهول التام عن نفسك. فمادام هناك مركز يوجِد حيِّزًا من حوله لا يوجد حبٌّ ولا جمال. أما حين ينعدم المركز والمحيط فإذ ذاك يوجد الحب. وحين تحب تكون أنت الجمال.
حين تنظر إلى وجهٍ قبالتك فأنت تنظر انطلاقًا من مركز، والمركز يوجِد الحيِّز بين الشخص والشخص؛ ولهذا فإن حياتنا بهذا الخواء والقسوة. ليس بمقدورك أن تنمِّي الحب أو الجمال، ولا بمقدورك أن تخترع الحقيقة؛ أما إذا كنت واعيًا طوال الوقت بما أنت فاعل فبمقدورك أن تنمِّي الوعي. واعتبارًا من ذاك الوعي ستبدأ برؤية طبيعة اللذة والرغبة والأسى، ووحشة الإنسان وسأمه المرعبين، وعندئذٍ ستبدأ بمباغتة ذاك الشيء المسمَّى “حيِّزًا”.
عندما توجِد حيِّزًا بينك وبين الغرض الذي ترصده ستعرف أن الحب يغيب؛ ومن دون الحب، مهما اجتهدت في إصلاح العالم أو في إحداث نظام اجتماعي جديد، أو مهما أسهبت في الكلام على تحسينات، لن تتسبَّب إلا في العذاب. فالأمر منوط بك. ليس هناك من قائد، ليس من معلِّم، ليس من أحد يخبرك بما أنت فاعل. أنت وحدك في هذا العالم المتوحش المجنون.
* From Freedom from the Known, chapter 11, copyright ©1969 Krishnamurti Foundation.
[1] See: J. Krishnamurti, Freedom from the Known, chapter 10, Harper & Row, New York, 1969.
[2] راجع: ج. كريشنامورتي، “المشكلات والزمن”، سماوات جديدة: http://www.samawat-jadidah.org/j_krishnamurti/by_k/problems_and_time. (المحرِّر)